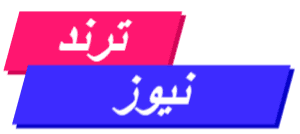اليامين بن تومي: أمراض التاريخ هي الأخطر على الثقافة الوطنية

بين الكتابة الروائية والكتابة النقدية والفكرية، يتموقع الكاتب والأكاديمي الجزائري وأستاذ تحليل الخطاب المتخصّص في النقد والآداب العالمية، اليامين بن تومي (1976)، مشغولاً بهواجس اللحظة الجزائرية والعربية، في تحوّلاتها المقلقة ومخاضاتها المختلفة.
“الشرق” حاورت بن تومي، صاحب كتاب “أمراض الثقافة في الخطاب الجزائري المعاصر”، ورصدت بعض هواجسه:
مرّ قرن على ما سمّي “صدمة الحداثة” لدى الإنسان العربي. يبدو أن الأسئلة نفسها ما تزال تُطرح بخصوص ثالوث (التراث. الحداثة. الهوية) بل هناك تراجعاً نحو قيم التعصّب والصدام، كيف تقرأ الأمر؟
إن الأساسات التي بنيت عليها الحداثة كانت مغشوشة أصلاً، لأن الأوهام الكبرى التي صنعها الإنسان الغربي حول حداثته، سرعان ما طعنت فيها كثير من المآلات كالاستعمار والحروب المختلفة التي حصلت في أوروبا، وبالتالي فإن مآلات الحداثة هي التي أوجعت ضمير الإنسان الغربي، وأدّت به إلى حالة الاحتقان والاقتتال.
بل إن الحداثة في ذاتها، أدّت إلى العصبية والبوهيمية، كما أدت إلى الكلبية التي تغوّلت فيها جميع أشكال الوحشية، وأفرغت المحتوى الإنساني من داخله، بمعنى أن الحداثة بالغت في شقّها الصناعي على حساب الإنساني، وهنا انقلبت الحداثة على نفسها، وأخرجت أبشع ما فيها.
امتلكت معظم المدارس الفكرية والسياسية القدرة على بعض الإقناع (يسار. إسلام سياسي. علمانية. قومية عربية) لكن بعد فشلها أي خطاب بقي قادراً على الإقناع؟
قراءة الواقع العربي، لا يجب أن تتم فقط على مستوى لحظة الصدمة التي حصلت بين التيارين؛ تيار يدّعي تحديث المجتمع العربي، والتيار التراثي الذي يدعو إلى الاعتصام بالماضي وقيمه، وإنما ينبغي أن نفكر في الأساسات التي انبنت عليها الثقافة العربية،
أعتقد أنها أساسات صدامية بالأساس: الصدمة الأولى تلك التي حصلت بين العرب والفرس، والصدمة الثانية التي حصلت بين العرب والفلسفة اليونانية، والصدمة الثالثة تلك التي حصلت بين العرب والتوسّع الإمبراطوري الاستعماري في نسختيه؛ البريطانية والفرنسية، وهي صدمة انتكاسة في الحقيقة، وليست صدمة إبداعية كما كان في اللحظتين الأولى والثانية.
وبالتالي ما عاشته الثقافة العربية مع الغرب في لحظتها الرابعة في تصوّري، يمثّل شكلاً من أشكال الزحام بين الإمبراطوريات، فالثقافة العربية ثقافة إمبراطورية، والغرب ثقافته إمبراطورية كذلك. وعليه، فإن الانقسامات المختلفة داخل هذه الثقافة، ليست وليدة الصدمة الرابعة، وإنما هي وليدة مسارات طويلة على مستوى بناء الثقافة العربية ذاتها، وبالتالي فإن اليسار واليمين كانا موجودين أصلاً، وإنما أعيد تجديدهما بمقولات ماركسية وليبرالية.
لقد أدّى هذا التجديد إلى الانتكاسات القديمة نفسها. وهنا حري بنا أن نقول إن الثقافة العربية ثقافة مأزومة في الأساس.
رصدت في كتابك “أمراض الثقافة” السياقات الموضوعية التي أدت إلى تلك الأمراض، لكنك قليلاً ما أشرت إلى المآلات في حال عدم علاجها. إلى أي أفق نحن ذاهبون؟
عالج الكتاب مسألة مهمة وهي، إذا لم نتدارك المعوقات والأمراض المختلفة التي تمنعنا من تأسيس لحظة إبداعية، فإننا سنظل نعيش الدور التاريخي الذي يؤدي بنا إلى ممارسة الأخطاء نفسها. وعليه فالنتائج التي نطرحها إنما تنطلق من تشخيص تلك الأمراض ومحاولة إنقاذ المستقبل من الوقوع فيها. إننا ما نزال نصنع مجدنا خارج الثقافة اليومية، وإنما نتحرك داخل ما صنعه أجدادنا، وهذا في حد ذاته يشكّل مانعاً من التحرّر نحو صناعة مصيرنا بأيدينا.
بعد ستة عقود من الاستقلالات الوطنية العربية؛ باتت دولنا تتوفر على ملايين الدارسين والمتمدرسين في مختلف المجالات. لماذا بقيت سلبية في فرض الأسئلة المتعلقة بالمستقبل؟
لأن المسألة في حالة القطيعة الرهيبة بين السؤال السياسي والسؤال الثقافي، ما تزال الممارسة تستّل حاجتها من شرعية الماضي، وليس من إنجاز وعود المستقبل. هذا الأمر جعلنا نعيش أزمة بنيوية حيث أسبقية الماضي على الراهن واليومي. وبالتالي فإن كل الطاقات مؤجلة ومفرغة المحتوى؛ لأنها خارج الإرادة التي تعيد إنجازات الماضي.
هل استطاعت الرواية العربية بعد قرن من الزمن أن تعي ذاتها وتخلق خصوصيتها، بالمقارنة مع روايات الشرق والغرب، وتطرح الأسئلة المتعلقة براهن الإنسان والمكان العربيين؟
الرواية العربية في الحقيقة تجربة رائدة في سماء الكتابة الإبداعية الإنسانية، ونستطيع أن نقول، إن التجاذب الذي حصل في أساس نشأة الرواية العربية من كونها ذات مصب غربي، لا ينفي بتاتاً كونها استطاعت أن تجد لنفسها طريقاً ثالثاً يتجاوز كل العوائق الإبستيمولوجية.
استطاعت الرواية العربية أن تناقش موضوعات مهمّة كالمقاومة والحرية والإنسانية، وأن تعاتب كثيراً الأساس المعرفي للرواية الغربية، من خلال نوع خاص من الرواية التي كتبت جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهي تُكتب بطريقة مختلفة عن المنشأ الغربي للرواية.
فإذا كانت الرواية الغربية ذات منشأ برجوازي، فإن الرواية العربية ذات منشأ تحرّري، فهي تنزع نحو تحرير الإنسان من كل القيود والأغلال، ولعل هذا الامر هو ما جعل الرواية العربية تتحرّر من البناء الفني والشكلي لما تم توارثه من الثقافة الغربية.
أنت تكتب الرواية وتدرّس نقدها معاً. إنك شبيه بمدرّب كرة القدم الذي يلعبها أيضاً. هل هذا عامل ثراء بالنسبة إليك أم يؤثر على عفوية الكتابة؟
إن معرفة النظريات السردية وطرق كتابة الرواية، وقراءة النصوص السردية الكبرى والنصوص السردية الوطنية، تجعل للكاتب خبرة ورصيداً في فهم الأساليب وفهم تقنيات الكتابة، وهذا ما يعمل على تحسين مستوى الكتابة لدى الناقد كاتب الرواية.
لكن هذا لا يعني أن الناقد دائماً كاتب ناجح، فهو في تصوّري قد يكون في كثير من الأحيان روائياً فاشلاً، لأن المبدع الذي يكتب من ذهن خالٍ من القواعد والأساسات الفنية للكتابة، مؤهّل لأن يأتي بنص جديد مختلف عن النص الروائي المدرسي، الذي نحترمه ونجله نحن كنقّاد، إذاً فالمبدع يتجاوز الناقد في كثير من الأحيان.
لماذا لم تتمكّن الجماليات العربية (رواية. شعر. سينما. مسرح. تشكيل. معمار..) أن تخلق حواريات فيما بينها، مثلما هو موجود في المشهد الغربي، وبقيت جزراً معزولة عن بعضها؟
أتصوّر أن مسألة الجماليات العربية بعيدة كل البعد عن الأساسات الاجتماعية التي يمكنها أن تنتج حواراً فاعلاً، أو نقاشاً، لأن الفضاء العربي سقطت فيه كل الأيديولوجيات التي يمكنها أن تحرّك الطبقة المثقفة، لأجل أن يناقشوا علاقة العمل الأدبي بالواقع، أو أن يناقشوا علاقة الجمال بالحضارة والعمران بشكل عام.
هناك قطيعة، بل قطائع حقيقية بين ما هو جمالي وما هو عمراني، ففي كثير من الأحيان تكون النصوص الإبداعية التي يكتبها المبدع العربي لا علاقة لها بالتطور العمراني، ولا بتطور الثقافة المدنية التي يسري إليها المجتمع العربي.
فالنصوص الإبداعية في الثقافة العربية معظمها عبارة عن سير ذاتية تستلف قيمها وأبعادها الجمالية من الصراع الجدلي الجذري بين التراث والحداثة؛ في حين أن الشعوب والإشكالات اليومية تتجاوز هذه الصراعات التي مر عليها الزمن.
يتم دوماً التركيز على قضية نكسة 67، أو الحركة البشرية الثالثة في الثقافة العربية التي تعمل على تحديث هذه المجتمعات، ويُغفل أن هناك تطوراً دينامياً وكرونولوجياً يتعرض له المجتمع العربي، بعيداً عن أي نكسة يمكنها أن تحرّك هذه المجتمعات.
يقودنا هذا إلى التساؤل عن تخلف الفلسفة في الفضاء العربي، وما شابهها من علوم مثل علم الاجتماع، عن الانتباه إلى التعابير/ الإنتاجات الفنية والأدبية، واتخاذها منصّة لقراءة الذوق العام والتحوّلات؟
تعيش الثقافة العربية اختلافا حقيقياً في الموضوعات والقضايا والمناهج، وبالتالي تجعل ما نكتبه من نصوص يُفرغ في جعبة الثقافة الغربية بشكل عام، فكثير من مثقفينا ومفكرينا وكتّابنا يناقشون كل من؛ كونديرا و لوكاتش ونيتشه وهايدجر وكادمير، ولم يتعرفوا بعد على أن حركة المجتمع بعيدة تماماً عن هذه المصبات التي يحتكمون إليها.
هناك ذوقين في الثقافة العربية؛ ذوق واقعي اجتماعي يعانيه الإنسان العربي البسيط، وذوق رفيع أكاديمي ومدرسي يتمسك به المثقف الرسمي، مع أنه في كثير من الأحيان نعيش لحظة سقطت فيها الأذواق المعيارية، لصالح ما هو شعبي ويومي، هذا ما أدى إلى اختلال حقيقي في الذوق العام الذي يحتفي بأغنية الراب، وأغنية الراي ويحتفي بالثقافات الشعبية المحلية، والذوق الرسمي الذي يحتفي بالنصوص الكبرى.
ولم يستطيع المثقف أن يجسر الهوة بين هذا النص الرسمي وبين تلك النصوص الشعبية، أو كيف نجعل مما هو الشعبي جزءاً من الثقافة الرسمية، أو جزءاً من الثقافة المدرسية بشكل عام، هذا الخلل أدى إلى اختلال وظيفي كبير في مسألة الذوق الجمالي ومسألة تذوق النصوص الإبداعية، لذلك ممكن لأغنية واحدة من مغني “الراي” أن يؤثر كثيراً في المجتمع، بينما لا تحدث رواية أي ضجة، ومن هنا نفهم الفرق بين الذوق الشعبي والذوق المتعالي. وهذا ما يؤدي إلى حالة الشرخ الثقافي في بيئاتنا العربية.
هل أنت مرتاح لانتعاش النقد الثقافي في مختلف مفاصل الحياة الأكاديمية العربية؟
نستطيع أن نقول إن النقد الثقافي هو الذي خلّص النقد بشكل عام من حالة انكفاء النص على ذاته كما يقول نقّاد البنيوية، حيث أعاد النقد الثقافي النصوص إلى الإنسان وثقافته، وأصبح النص يترجل في واقعياته المختلفة، أنقذ النصوص من حالة الضياع والتيهان، ولكن هذا النقد أصبح ينتصر للموضة التي تنتشر في أميركا وأوروبا بشكل عام، ونحن نعرف أن النصوص المحلية تنبع من الثقافة الحقيقية، والثقافة العمومية، الثقافة الأصلية للشعوب، وكأن هناك انتصاراً بشكل ما لمركزيات هامشية جديدة على حساب الثقافات المحلية الحقيقية التي يجب أن ننتصر لها، وأن ننصفها.
لذلك فإن النصوص التي تؤثر في العادة هي تلك التي تأتينا من الهوامش؛ فتُعرِّفُنا على معطيات أخرى مغيّبة، وتغرق كثيراً في الفضاء والأسماء والأشياء، بعيداً عن نصوص الفكرة التي ما زالت تتعلق بذلك المثقف الذي يبحث عن المآل، أو يبحث عن الخلاص. إن المستقبل في الأدب العربي لنصوص الهوامش.
بالعودة إلى أمراض الثقافة لكن في السياق الجزائري تحديداً. ما هي أهم الأمراض التي تراها تعيق انبثاق حركة ثقافية حقيقية؟
عالجت في كتابي “أمراض الثقافة” التشوّهات الكبرى في الثقافة الجزائرية، وأخصّ بالذكر أننا كجزائريين، نعاني مرضاً تاريخياً فظيعاً، هو كوننا نصنع الأمجاد في الماضي، ولا نصنعها في الحاضر، وكل شرعيات الحاضر والمستقبل ننطلق في بنائها من شرعية الماضي، وكأنه لا وجود في المخيال الجمعي للحاضر والمستقبل.
وبالتالي فإن عدم تقدير إشكالية الزمن ستفقد الإنسان قيمته الحضارية، وستفقد الإنسان قوة الفعل التي يمكنها أن تحرّك الواقع، وأن تغيّر فيه. إن مرض التاريخ هو من أخطر الأمراض التي تعانيها الثقافة الوطنية في مفهومها الطبيعي.